كان اليوم "يوم رياضي": كان علينا حضور حلقة نقاشية حول منتج ما في شركة لبحوث التسويق. أجلس مع مديري المباشر وزميلتي المسؤولة عن هذا المنتج في غرفة العملاء مع اثنين من العملاء، شاب وشابة، يدخنان بشراهة. الشابة تبدو لي على شفا انهيار عصبي، والشاب بطيء جداً في ردود فعله ويسمع الكلام ثم يردده كأنه هو الذي فكر فيه لتوه. المكان المثالي لمثل هذه المناقشات يتكون من غرفتين متلاصقتين: إحداهما للعملاء والأخرى للمجيبين، والحائط الذي يفصل بين الغرفتين زجاج من ناحيتنا ومرآة من ناحيتهم، بحيث نستطيع نحن أن نرى المجيبين ويظلون هم طوال المناقشة يعدلون ملابسهم ويتفقدون تسريحة شعرهم أمام ما يظنونه مرآة كبيرة. نحن هنا اليوم لنرى كيف يفكر المستهلك البريء الذي سنهاجمه بعد ذلك بوابل من الإعلانات تجبره على شراء منتج العميل نقول فيها إن هذا المنتج بالتأكيد هو الأفضل والأرقى والأسرع والذي سيحل كل مشاكلكم، حتى المشاكل التي لم تكونوا على دراية بوجودها من الأساس. وسيجعل هذا المنتج كل السيدات جميلات وكل الرجال جذابون. كم أكره عملي أحياناً!
ولكن لأكون صادقة أنا غالباً ما استمتع بهذه المناقشات. أولاً، أن أكون غير مرئية هو شيء أتمناه في كثير من الأوقات. عندما كنت صغيرة (وحتى وقت قريب) كنت أفكر ملياً فيما سأفعل إذا كانت لدى "طاقية الإخفا"، وأفكر في سيناريوهات أعرف فيها ماذا يقول الناس في غيابي وأين يخبئ أخي الشوكولاتة، بل وأفكر في أخلاقيات استعمال "طاقية الإخفا". ثانياً، الموضوع برمته كوميدي جداً ومفيد للغاية، وتعليقات المجيبين تذهلني كل مرة بذكائها الحاد أو غبائها المطلق ولكنها في كل الأحوال تضيف عمق لرؤيتي للعديد من الأمور. اليوم مثلاً اكتشفت أنه ربما كان أحد أسباب السحابة السوداء التي نعاني منها في الخريف في القاهرة هو إشعال الفلاحين للأقراص الطاردة للناموس مباشرة بدلاً من وضعها في الجهاز الكهربائي المخصص الأقراص! فعلاً...اللي يعيش ياما يشوف، واللي يحضر "جروبس" (groups) يشوف أكتر!
من الأسئلة التقليدية التي توجه لي: "إنتي بتشتغلي إيه بظبط؟!" للأسف أنا لا أعمل مذيعة كما كنت أتمنى طول حياتي، ولا أعمل بالكتابة بعد؛ أنا أعمل "كوبي رايتر" في شركة دعاية وإعلان. عندما سألتني صديقتي العام الماضي: "تحبي تشتغلي معانا كوبي رايتر؟" كان أول ما جال بخاطري: " يعني إيه كوبي رايتر؟ هاصور ورق يعني وإلا إيه؟!"
يتكون أي إعلان عادةً من صورة (visual) وكلام (copy)، وبالتالي فالكوبي رايتر (copywriter) هو الشخص المسئول عن تأليف كلام الإعلانات. أجد الكلمة بالفرنسية أوضح (rédactrice publicitaire) أو محرر إعلاني/محرر إعلانات. حاول أحد أصدقائي المترجمين مساعدتي في إيجاد ترجمة صحيحة للكلمة الإنجليزية فاقترح "محررة فنية" ولكني اعترضت بشدة. أنا مش شغالة في مجلة الموعد!
يتطلب عملي ترجمة المطبوعات والأدلة الإرشادية والمواد الدعائية لعملائنا، وتأليف سيناريوهات لإعلانات الراديو والتليفزيون، والكثير من الإعلانات المطبوعة في الجرائد والمجلات، بالإضافة إلى تنقيح وتصحيح أي إعلان قبل أن يخرج من الاستوديو للطباعة.
وبالطبع بعد عام من العمل هنا بدأت أعاني من العديد من أمراض المهنة: فأنا أرفع صوت الراديو عند الفقرة الإعلانية وأخفضه عند الأغاني، وأجلس في منتهى التركيز أمام إعلانات التليفزيون في انتظار إعلاناتنا أو لأعرف ماذا يقدم المنافسون، ثم أقوم بعد أن تنتهي الإعلانات. كما أصبحت أجد عيني تقع على الأخطاء الإملائية بطريقة لا إرادية وتأكلني يدي رغبة في تصحيحها. منذ فترة أرسل لي نفس صديقي المترجم بمنتهى الفخر المقرر الدراسي الذي يدرسه لطلابه في الخارج، وكان أول تعليق لي: "عندك غلطة إملائية في تالت سطر"، وبعد أن قلت ذلك أدركت أن المرض تمكن مني. أصبحت أرى الهمزات حيث يجب أن تكون، والتاء المربوطة مكان الهاء في آخر الكلمات، والنقاط تحت الياء في كلمات مثل "مصري" عندما يكتبونها "مصرى"، وأغتاظ عندما أرى أخطاء مثل "مساءاً" (وصوابها مساءً).
لم يكن لديهم قبلي هنا في الشركة محرر إعلاني، ومن المضحك أنني لا اعتبر نفسي ضليعة في اللغة العربية، بل هناك قواعد بسيطة جداً مازلت تختلط عَلَى وقواعد أخرى لا أفهمها بتاتاً، وبالرغم من ذلك جعلوني المحرر المسئول عن أي شيء باللغة العربية بعد خمسة أشهر من انضمامي للشركة، اقتناعاً منهم أنني أقوم بعمل جيد، وأتوا بزميلة جديدة لتكون مسئولة عن الإنجليزية لتخفيف العبء عني. يشعر زملائي في العمل بالطمأنينة والأمان عندما أقول عبارات مثل "العدد من تلاتة لتسعة يخالف المعدود" أو "ده فعل ثلاثي مش بياخد همزة في الأمر"، ويشعرون أنهم يحصلون على معلومات هامة من مصدر مسئول. ويتيح لي عملي امتياز رائع: استعمال قلم أحمر أحذف به كل ما لا يروق لي. ولكن بالرغم من حرصي الشديد على مراجعة كل شيء واتخاذي لكافة الاحتياطات عند الكتابة، فأنا متأكدة أن هناك أخطاء تغافلني، ومما لا شك فيه أن هذه التدوينة نفسها حافلة بالأخطاء.
قبل عملي الحالي، وقبل اتجاهي تماماً للترجمة، عملت فترة في مجال بحوث التسويق، وكان مكاني في الجانب الآخر من الغرفة. لا، في البداية كنت أجلس بداخل غرفة العملاء، أترجم أو أدون الملاحظات. لاحقاً تمت ترقيتي فدخلت غرفة المجيبين وكان على أن أسألهم عن نظام حياتهم، وعدد أفراد أسرتهم، ولماذا يستخدمون هذا المنتج أو ذاك. بقدر إعجاب مديري بقدرتي على إدارة تلك النقاشات، بقدر ما كان يغتاظ مني لعدم قدرتي على التحكم في تعبيرات وجهي ونبرات صوتي، فأنا إذا أدهشتني إجابة اندهشت، وإذا استنكرت كلام ما ظهر على وجهي استنكاري، الأمر الذي لا يساعد المجيبين كثيراً في التعبير عن أنفسهم. حاولت أن أتحكم في تعبيراتي ولكن بلا جدوى فكففت عن المحاولة وكف هو عن الغيظ أو على الأقل عن التعبير عن هذا الغيظ. حتى الآن أواجه هذه المشكلة، وغالباً ما اسمع تعليقات مثل: "اضحكي اضحكي...ما تكتميش في نفسك" (عندما أحاول أن ارسم ملامح الجدية على وجهي) أو الجملة الأشهر "شكلك مش مقنع خالص وإنتي بتقولي كده!" (عندما أحاول أن اكذب). تعلمت حيلة من عملي السابق لاكتشاف ما إذا كانت أي مرآة حقيقية أم زجاج مزدوج يمكن أن يكون وراءه أشخاص أشرار (مثلنا) يراقبونني: تضع إصبعك على المرآة وإذا وجدت أن هناك مسافة بين إصبعك وانعكاسه في المرآة فهي إذن زجاج مزدوج، ورجاء لا تخلع ملابسك في هذا المكان.
اليوم في المناقشة وجدت نفس الإجابات ونفس العقبات. عند السؤال الذي يُطلب فيه من المجيبين أن يتخيلوا شخصية المنتج محل المناقشة أو يحلموا بالمنتج المثالي يُسقط في يدهم. الجميع يخشى الحلم، ولكن الجميع يطمع في كل شيء. أتذكر قصيدة لأحمد: "كله بيخاف لما يعيش". المجيبات ترددن كلام مأخوذ من الإعلانات والبرامج التلفزيونية وأقرأه في مجلات الموضة عند مصفف الشعر. لا أستطيع أن أحدد أيهما بدأ أولاً: الإعلانات خلقت لغة معينة دخلت في وعي المستهلكين، أم الإعلانات أخذت من لغة المستهلكين لتشكل وعي مستهلكين آخرين؟ أنا هنا لأتعلم منهم، ولكنهم يتكلمون كالإعلانات، فمن أين أبدأ؟
ارتكبت نفس الخطأ: لم أحضر شيئاً ثقيلاً أرتديه اتقاءً لشر مكيف الهواء. في عملي السابق، ومؤخراً في كل شركات بحوث التسويق التي نعمل معها، دائماً ما أعاني من التجمد في غرفة العملاء. ولكني اليوم تذكرت أن أحضر معي زجاجة مياه والكثير من اللبان بطعم القرفة. المياه لئلا ينخفض ضغطي من الجوع والبرد، واللبان لإبقائي مستيقظة طوال الخمس ساعات التي ستستغرقها المناقشات اليوم.
حيث أنني في غرفة العملاء كعميلة فأنا غير مضطرة لكتابة الكثير من الملاحظات، فقط بعض ما تقوله المجيبات من كلمات أو تعبيرات تعجبني، لذلك استمتع برفاهية الشرود بعيداً. أفكر في باقي اليوم ومشاريعي بعد العمل: لن أعود للمكتب مع زملائي حيث أن شركة البحوث بجوار منزلي والمكتب في الطرف الآخر من الكوبري. سننتهي في الساعة الثانية. ماذا أفعل؟ معي في حقيبتي "الست ماري روز"، يمكنني أن أحتسي القهوة في أي مكان قريب أحبه، فأنا هنا بالقرب من كل أماكني المفضلة لاحتساء القهوة. أو يمكنني أن أصلح حذاء مقطوع يمكث في سيارتي منذ بداية الصيف في انتظار الإصلاح. أو يمكنني أن أتفقد المحلات والأوكازيون. أتذكر الحر خارج هذه الغرفة المثلجة فأصرف كل فكرة فيها سير في الشارع. لدي موعد مع الطبيب في المساء وندوة، والاثنان في وسط البلد. من الأفضل إذن أن ادخر طاقتي. أحياناً تروق لي فكرة أنه رغم هذا القدر الكبير من الحرية والانطلاق والاحتمالات اللامتناهية أقرر-بمنتهى الحرية والانطلاق أيضاً-أن أعود للمنزل لأنام أو أقرأ. وفي أحيانٍ أخرى تصيبني نفس الفكرة بالإحباط، خاصة عندما أجد نفسي لا أريد القيام بأي من "الاحتمالات اللامتناهية" لأني بمفردي.
مع الحلقة النقاشية الثانية يصيبني الملل فأقرر أن أقوم ببعض التمارين للذاكرة. لدي اعتقاد مبني على شيء ما قرأته-ولا أتذكره الآن كالعادة-أنني إذا دربت ذاكرتي ستتحسن وسيقل احتمال تعرضي للزهايمر المبكر. الشهور العربية تبدأ بمصر، ميم صاد راء، محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمادى أول جمادى ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. يناير هو كانون الثاني، فبراير شباط، مارس آذار، أبريل نيسان، مايو أيار، يونيو حزيران، يوليو تموز، أغسطس آب، سبتمبر أيلول، أكتوبر تشرين الأول، نوفمبر تشرين الثاني، ديسمبر كانون الأول.
وحدها نتيجة الشمرلي كان بها التقويم القبطي الذي ما زال يستخدمه الفلاحون لمعرفة مواقيت الزراعة، وجميع الأعياد بما فيها القبطية ومواعيد النوات بالإسكندرية. لم أحفظ من الشهور القبطية سوى تلك التي أعرف لها أمثال شعبية: كيهك ("تقوم من النوم تحضّر عشاك"، كناية عن قِصر اليوم في ديسمبر/يناير الذي يتزامن مع كيهك. ويُنطق "كياك")، طوبة ("يخلّي الشابة كركوبة"، كناية عن البرد الشديد في يناير/فبراير)، وأمشير المشهور بزعابيبه والذي يتزامن مع فبراير/مارس. وكان بتلك النتيجة أيضاً دليل لخطوط سير أوتوبيسات النقل العام والميكروباص وجدول بمواعيد القطارات. كانت أسرة الشمرلي تسكن في المنزل المقابل لمنزل جدي بشبرا، وكانوا يهدونا عند كل بداية عام دراسي رزم من الكراريس والكشاكيل بمختلف أنواعها. أثناء كتابتي لهذه التدوينة قمت ببعض البحث عن أسماء الشهور القبطية فاكتشفت أنهم ثلاثة عشر شهراً، منهم شهر من خمسة أيام فقط (أو ستة في السنوات الكبيسة). لم أكن أعرف ذلك! تذكرت الآن أن هناك أمثال شعبية تُطلق على برمهات ومسرّي وتوت وبابه ولكن لا أتذكر الأمثال نفسها (ربما يجب أن أُكثر من تمارين الذاكرة تلك).
نتململ أنا ومديري وزميلتي من الجلوس هكذا طويلاً، فنحن في المكتب نادراً ما نظل على مكاتبنا أكثر من نصف الساعة. لتضييع الوقت يُخرج المدير من حقيبته كيس كبير من الدببة الجيلاتينية ومصاصات وشوكولاتة نأتي عليها كلها ويمتنع العملاء عنها حيث أن كلاهما يتبع حمية تمنعهم-بالطبع-من الحلويات. أتذكر جملة قالها طفل جميل في فيلم فرنسي، "الأكل المالح للتغذية، فقط لملأ المعدة، ولكن الحلو...امممم....الحلو هو جوهر الحياة!"
أعود للمنزل جائعة جداً لأجد المكيف معطل وأمي قد اشترت كل كتب سلوى بكر التي وجدتها عند مدبولي اليوم وجلست منهمكة جداً في قراءة "البشموري" وعازفة عن الحوار معي. أجد شيئاً غريباً جداً في طبق صغير جداً بالمطبخ تزعم أمي أنه سُبيط مشوي. بعد إضافة الكثير من الملح والليمون له أشعر أنني آكل مخلل بطعم السمك. أحتسي القليل من شوربة البارحة ثم أجد ثمرة مانجو وحيدة بالثلاجة فينشرح قلبي. أشمها بعمق لأتأكد من أنها جيدة. أجلس على طاولة الطعام ممسكة بالست ماري روز بيد والمانجو باليد الأخرى. أقضم قشرة المانجو فأجدها لذيذة فابتسم واترك ماري روز لأتفرغ للمانجو. هناك أكلات تستدعي طقوس معينة لأكلها، فالمانجو يُفضّل أن تؤكل في البانيو، درءاً للبقع، والبسطرمة يجب أن تستحم بعد أن تأكلها لتتخلص من رائحة الثوم والحلبة التي تنفذ من مسام الجسم بغض النظر عن عدد المرات التي تغسل فيها يديك بعد طبق من البسطرمة بالبيض.
لا أستطيع أن أواجه غرفتي في هذا الوقت من اليوم لأنها في الجانب القبلي من الشقة و"منقوحة" في الشمس طوال النهار. أتمدد على أول أريكة تقابلني وأنام نوم مضطرب أشعر أثناؤه أنني نمت لوقت قصير جداً واستيقظ لاكتشف أنه فاتني موعد الطبيب والندوة. حسناً...هذه نهاية غير متوقعة لكل الاحتمالات اللامتناهية. هي ليلة للقراءة إذن!
Monday, September 19, 2005
يوم رياضي
Friday, September 16, 2005
أن تنسى
أدركت اليوم أنني نجحت في تحقيق ما ظل الجميع يحثونني عليه: نجحت في التأقلم. بعد شهور عديدة تأقلمت على فكرة الفراق، وهي الفكرة التي ظللت طيلة كل تلك الشهور أستغربها ولا أفهمها: لا أفهم كيف أكون أنا هنا في حين يكون هو هناك، لا أفهم كيف يكون هنا هناك وهناك هنا، بعد أن كان كل شيء هو "هنا" وحسب. لم أستوعب. أظنني كنت أقاوم الاستيعاب.
"أبشع شيء ليس الحزن ولكن اختفاء الحزن".*
عندما قرأت هذه الجملة في حينها تعاطفت وتنهدت بحرقة، وقلت إن الموضوع برمته محزن. ولكنني أُدرك الآن أنني لم أفهم شيئاً.
من المحزن فعلاً أن تتأقلم، أن تعتاد الوضع. أن تكف عن التفكير والتذكر. أن تكف عن محاولة الامساك بتلابيب الذكريات. أن تنسى وتستكين لهذا النسيان. أن تنسى، ولا تقوم من نومك في منتصف الليل لتقرأ رسالة قديمة أو تنظر لصورة ما. أن تتخلص من هذا الوجود اللاموجود لذلك الحزن الرابض في خلفية عقلك، والذي يتحكم في كل تصرفاتك ومزاجك؛ وجود يشبه صوت جريان الدم في جسمك: هو بالتأكيد موجود ولكنك لا تسمعه ولا تستطيع تحديده أو إسكاته.
أن تنسى هو أن يمضي اليوم بدون أن تتساءل ماذا يفعل ذلك الشخص الآن. أن يمضي اليوم، والغد، واليوم الذي يليه بدون أن تتوقف لتلتفت حولك وتتساءل أين هو. أن تعتاد البُعد، أن تعتاد أن تكون وحدك، أن تقتنع أنك وحدك. من المحزن ألا تتوقع شيء، وعندما يحدث شيء غير متوقع لا يثير فيك فرح أو شجن، فقط تعجب عابر تستمر بعده في كي ملابسك والتفكير في اليوم المسجى أمامك. أن تفقد المفاجآت والمتوقعات بريقها على حد سواء، فلا تستغرب المفاجأة ولا تستنكر المتوقع.
تنسى فيصبح كل شيء بدون طعم، ليس لأنك حزين أو وحيد، ولكن لأن كل شيء فعلاً ليس له طعم. أن تفكر في شيء ما ولا تتوقف عنده، لا أن تتظاهر بأنك لا تفكر فيه...لا...أن تتخطاه وتستمر بالفعل. أن تستمع لأغنية حزينة تحبها فلا تظل تسمعها بلا انقطاع (كما كنت تفعل في الأيام الأولى)، ولا تهرع لإيقافها (كما كنت تفعل في الأيام التي تلت ذلك)، بل تسمعها ولا تتذكر حتى أنك سمعتها. أن تُسأل عن "الأخبار" فلا يؤلمك شيء وأنت تقول "تمام...كله تمام"، وتنتقل بالحوار لأشياء أخرى ملموسة أكثر، لتتكلم عنها بصدق واستغراق وبدون أي تظاهر بالاهتمام.
أن تنسى هو أن تكتشف الصمت، بعد صخب كل تلك الأفكار وكل ذلك الكلام الذي تتمنى أن تقوله. أن تختزن الحكايات، وعندما يحين وقت قصها تشعر بأنك فقدت الرغبة في الكلام، وتقتنع بأن الآن ليس الوقت المناسب. تنسى أن نصفك الآخر مريض، أو حزين، أو لديه مشاكل ما، فلا تؤنب نفسك على هذا النسيان، بل تنسى أنك نسيت. أن تنسى هو أن يصبح السؤال "كيف سأتأقلم على الوجود"، بعد أن كان "كيف سأتأقلم على الغياب".
وتظن أن كل ذلك النسيان سيحررك، سيجعلك تعيش حياتك بطريقة أكثر طبيعية، سيجعلك أكثر اتساقاً مع واقعك، فتفاجأ أن الموضوع تعدى مجرد تفادي العائلة والأصدقاء، الخروجات والزيارات، والتوقف عن ممارسة ما تحب، فلقد أصبحت فعلاً تتوق للعودة إلى المنزل والنوم مبكراً لتُنهي هذا اليوم بيدك، لتشعر أن وسط كل هذا العبث مازال لديك الاختيار بين أكثر من طريقة لإهدار أيامك.
* بهاء طاهر من قصة "أنا الملك جئت".
Wednesday, September 14, 2005
Thursday, September 08, 2005
من جوه اللجنة
دي صور أخدتها في اللجنة الانتخابية بنادي السكة الحديد بمدينة نصر

ميكروباص ضمن 11 ميكروباص تبع مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة في مدينة نصر. الميكروباص ده وأصحابه راح وجه من عزبة العرب تلات مرات وده من الصبح لحد الساعة 3 لما رحت اللجنة

مواد دعائية لحسني على باب اللجنة

اقبال جماهيري فظيع على التصويت (أغلب الناس ما لقيتش أسماءها في اللجنة دي أو لقت رقمها باسم أو اسمين مختلفين وفي الآخر قالوا لهم يروحوا يصوتوا في لحنة في عثمان بن عفان)

وآدي قائمة بأسماء الناخبين...بعون الله هتلاقي اسمك...هي القائمة مش مترتبة أبجدي...والأرقام غلط...ورقمك غير اسمك واسمك غير رقمك...لكن إن شاء الله خير.

ولا كأننا في طيارة...شاب شيك ظريف بيشرب مارلبورو لايت وعصير جهينة ولابس قميص مشجر بياخد منك ورقة شبه البوردينج باس اللي بتطلع به الطيارة وتقعد في كرسي جنب الشباك أو على الممر...ده طبعاً لو انت جاي تبع الحزب الوطني ومندوبين الحزب اللي في اللجنة ادولك الورقة دي من غير لا بطاقة بامبي ولا حاجة...الأخضر ثم الأخضر ثم الأخضر

ده شكل البوردينج باس (boarding pass) إياه

ده منظر للجنة من جوه...اقبال اقبال يا ربي...بيحوشوا في الناخبين مش قادرين. الصورة باين فيها ورا الولد عسكري قاعد. ده في منه على باب كل لجنة
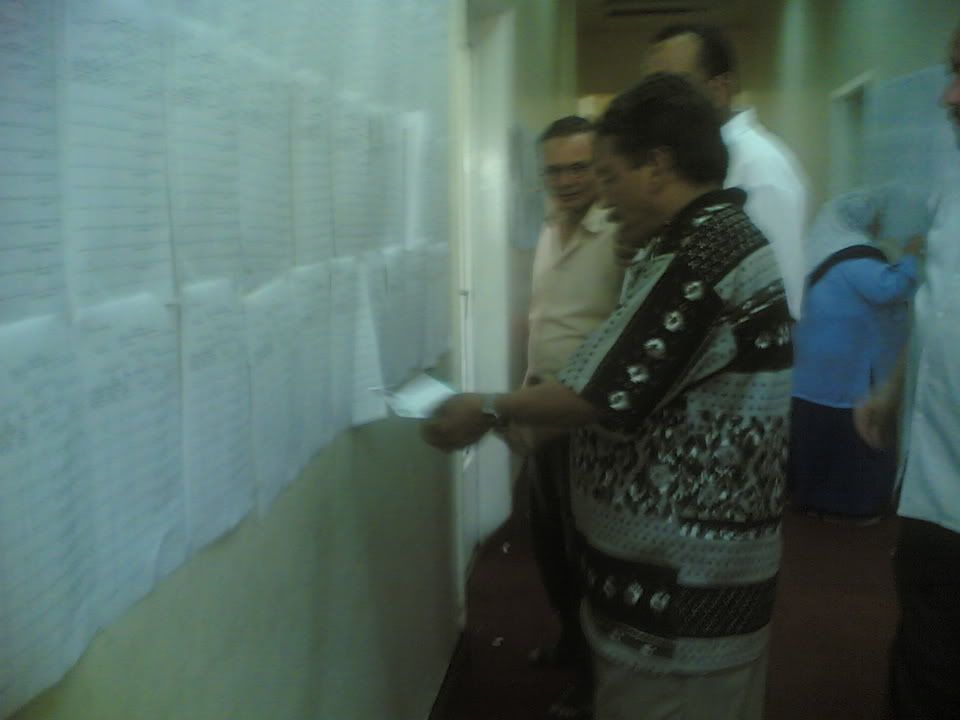
محتاس...نفسه ينتخب...غالباً أسهل له إنه يغير اسمه من إنه يلاقي اسمه الحقيقي في القوائم دي

طبعاً جه وقت الغدا وكل الناس (إياهم) أكلت...إحنا اشترينا ميه وشربنا الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم...شادي من مدرسة الوطني يوكل...إجابة السؤال الأول: مصر...والثاني: نعم...والثالث: أيوالله

المتسابقة الفائزة

صورة مهزوزة خالص بس دول مندوبين الحزب الوطني اللي بيطلعوا للناس بتوع الحزب ورقة الحزب علشان ينتخبوا (الحزب برضه)
طبعاً مافيش دعاية للريس جوه اللجان...انتوا هتهرجوا!

ده صباع مها...متفسفر خالص

وده نفس الملصق الدعائي بس الساعة 9 بليل
ثريا لبنه بقى كانت عامله تسهيلات للمواطنين اللي هيموتوا ويصوتوا...بلا بامبي بلا خوتة!

Wednesday, September 07, 2005
التردد يا عزيزي أيـبـك
5 سبتمبر صباحاً:
طب وبعدين...أنا دلوقتي عاوزه أروح انتخب ومش معايا بطاقة انتخابية. في ناس بتقول إني ممكن يومها أروح القسم ويطلعوا لي بطاقة في ساعتها، ودي حاجة أنا مستبعداها، وفي ناس قالت لي أروح القسم وأقول إن بطاقتي ضاعت وأطلع بدل فاقد ودي حاجة ناس نجحت تعملها وناس تانية قالوا لهم امشوا انجروا من هنا.
ها...أعمل إيه؟
تحديث بتاريخ 7 سبتمبر الساعة 2 الظهر:
ما ينفعش تنتخبوا بالبطاقة الشخصية فقط، بس ينفع تطلعوا البطاقة الانتخابية بطريقة بدل الفاقد حتى لو ما طلعتوهاش قبل كده...أهم حاجة الإنكار التام...تقولوا إنكم مش فاكرين طلعتوها منين ولا ضيعتوها فين :)
وسمحوا لممثلي المجتمع المدني من المرصد الانتخابي يراقبوا الانتخابات، في بعض اللجان منعوهم يدخلوا جوه اللجنة، وفي بعضها سمحوا لهم ودخلوا وقاعدين مع القاضي دلوقتي.
وسنوافيكم بالأخبار تباعاً!
Sunday, September 04, 2005
كيف يبايعون الرئيس في شارعي
ألف وأدور في الشوارع الجانبية حتى أستطيع أن أدخل للشارع الذي يقع فيه كوافير محمود بدون أن اضطر للدخول في معمعة الشارع الرئيسي. يخطر لي للمرة الألف أنه كان من الأسهل أن اذهب للكوافير سيراً. تلفت نظري لافتة ضخمة على أول شارعنا الجانبي الصغير: "كوافير هنومة يبايع السيد الرئيس حسني مبارك". لا أدري لماذا أذهلتني هذه اللافتة بالذات في خضم اللافتات التي سدت نور الشمس في الفترة الماضية. ربما لأني أعرف هنومة شخصياً، وزوجها وابنها الذي مات بجرعة مخدرات زائدة، وأعرف أنها ليس لها مواقف سياسية ولا حتى لا سياسية، كما أعرف أنها ليست عضو في مجلس الشعب، ولا أظنها تطمح لذلك. فلماذا إذن هذه اللافتة؟
وصلت عند محمود (وهو شخصية تستحق مسلسل رمضاني كامل وليس فقط قصة صغيرة)، وسلمت عليه ثم رسمت على وجهي إمارات الاستنكار الشديد: "إيه يا محمود؟! إيه اللي إنتوا فيه ده! إزاي لحد دلوقتي ما حطيتوش يافطة مبايعة الريس؟!"
هز محمود رأسه أسفاً: "والله أنا قلت لشريكي لكن هو رفض...رغم إني كنت ناوي أعمل حاجة مختلفة خالص!"
فاجئني رده فأخذت في الضحك: "حاجة مختلفة خالص إزاي يعني؟ كنت هتعمل له "هايلايت"؟ ولا "نيو لوك" بفورمة جديدة؟!"
"اضحكي اضحكي...أنا باتكلم جد. أنا كنت ناوي اعمل من الناصية بتاعتي للناصية اللي ادامي تعليقة من القماش بتاع الصوان...الملون ده...واكتب على قماش نضيف كده "كوافير محمود يبايع السيد الرئيس...برنامج خاص للعرائس" واجيب فروع نور بتطفي وتنور كده...ولا حد يقدر يجي يقول لي شيل اليافطة دي".
"ومين يقدر يجي يقول لك شيل يافطة الريس؟"
"لأ مش يافطة الريس...يافطة دعاية المحل...تكونيش فاكره إن كل اللي حاطين يفط دول بيبايعوا الريس بصحيح؟ ولا يكونوا منافقين وحشين؟ لأ! دي كلها دعاية...أيوه طبعاً! دول بيعملوا دعاية لنفسهم على قفا الانتخابات. هو أنا لو حبيت اعمل التعليقة دي على إنها دعاية للمحل تفتكري بتوع الحي هيسيبوني؟ لأ طبعاً! ده إنتي علشان تحطي أي يافطة أو تعاليق نور في الشارع لازم تجيبي إذن من الحي...والحي يوافق لك أو ما يوافقش...وكمان يقول لك تحطي كام لمبة في فرع النور!"
خرجت من عند محمود بشعر أكثر نعومة ومخ أكثر استنارةً. شكرته بحرارة قبل أن اخرج، فلولاه لكانت أخذتني الظنون بهنومة وتوجهاتها، وربما كنت قاطعتها أيضاً!
